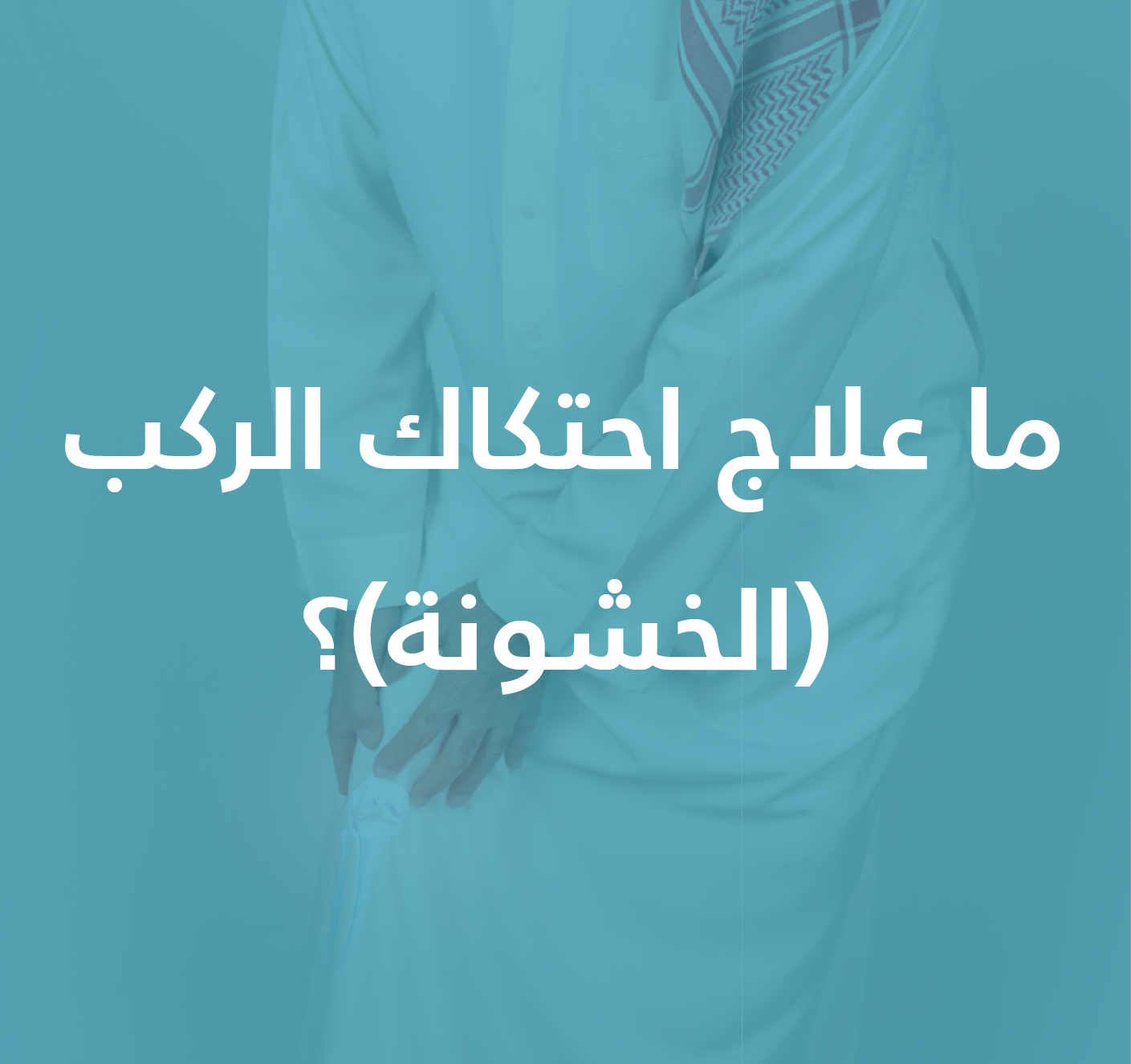الأمراض المنقولة جنسيًا
الأمراض المنقولة جنسيًّا تسببها العدوى المنقولة، بفعل الاتصال الجنسي. تنتج العدوى المنقولة جنسيًا عن البكتيريا، أو الفيروسات، أو الطفيليات. وقد تنتقل العدوى المنقولة جنسيًا من شخص لآخر عن طريق الدم، أو السائل المنوي، أو الإفرازات المهبلية، وإفرازات الجسم الأخرى، أو استخدام الإبر لأكثر من شخص أو بالتلامس المباشر. في بعض الأحيان تنتشر العدوى المنقولة جنسيًا بطرق أخرى غير الاتصال الجنسي، كأن تنتقل مثلًا إلى الرضع أثناء الحمل، أو الولادة. لا تسبب العدوى المنقولة جنسيًا أعراضًا دائمًا. وقد تنتقل من أشخاص يبدون بصحة جيدة، وقد لا يكونون على علم بإصابتهم بالعدوى. يمكن أن تسبب الأمراض المنقولة جنسيًّا مجموعة من الأعراض، وقد لا تسبب أي أعراض على الإطلاق. ولهذا ربما لا تظهر العدوى المنقولة جنسيًا إلا عند حدوث مضاعفات، أو تشخيص إصابة أحد الزوجين بها. يمكن أن تشمل أعراض العدوى المنقولة جنسيًا ما يأتي: قد تظهر أعراض العدوى، المنقولة جنسيًا بعد التعرض للعدوى بأيام عدة. وقد تمر سنوات قبل ظهور أي مشكلات ملحوظة، وهذا يتوقف على نوع الكائن الحي المسبب للعدوى المنقولة جنسيًّا. يمكن أن تحدث العدوى بالأمراض الجنسية التناسلية بسبب: ١- البكتيريا. من أمثلة الأمراض المنقولة جنسيًا التي تسببها البكتيريا مرض السيلان، مرض الزُهري، ومرض المتدثرة. ٢-الطفيليات. داء المشعرات أحد أنواع الأمراض المنقولة جنسيًا التي يسببها طفيل. ٣- الفيروسات. تشمل أنواع الأمراض المنقولة جنسيًا التي تسببها الفيروسات فيروس الورم الحليمي البشري، وفيروس الهِربس، وفيروس نقص المناعة البشري الذي يسبب الإيدز. عوامل الخطر: أيُّ شخص نشط جنسيًا يخاطر بالإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا (STD)، أو نشرها. العوامل التي قد تزيد خطورة الإصابة بعَدوى منقولة جنسيًا، تتضمَّن: انتقال العدوى من الأمهات إلى الأطفال الرضَّع: يمكن أن تنتقل بعض أنواع العدوى المنقولة جنسيًا من الأم إلى الجنين أثناء الحمل، أو الولادة، مثل: السيلان وداء المتدثرة، وفيروس نقص المناعة البشري، وداء الزُهري. وقد تسبب العدوى المنقولة جنسيًا لدى الرُّضع مشكلات خطيرة، أو تؤدي حتى إلى الوفاة. لا تظهر أي أعراض على الكثير من الأشخاص في المراحل المبكرة للأمراض المنقولة جنسيًا. ولهذا السبب فإن الفحص مهم لمنع المضاعفات. هنالك كثير من الطرق لتجنب الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا (STD)، أو لتقليل خطر الإصابة بها: قد لا تسبب بعض الأمراض المنقولة جنسيًا أي أعراض، أو قد تسبب أعراضًا بسيطة فقط. و حتى مع عدم ظهور أي أعراض، يمكن أن تنتقل الأمراض المنقولة جنسيًا إلى الآخرين. ولا يمكن التأكد مما إذا كنت مصابًا بمرض منقول جنسيًا إلا عن طريق إجراء اختبار. يسهل علاج بعض أنواع الأمراض المنقولة جنسيًا، والشفاء منها. بينما تكون أنواع أخرى أكثر تعقيدًا. ومن المهم تلقي العلاج حتى لا يُنقل المرض. كما يمكن أن يساعد العلاج على الوقاية من التعرض لمشكلة في الخصوبة، أو ضرر في الأعضاء، أو بعض أنواع السرطان. بعض أنواع الأمراض التناسلية المنقولة بالجنس: أعراض المتدثرة (Chlamydia) داء المتدثرة: عدوى تصيب الجهاز التناسلي، ويسببها نوع من الجراثيم المعروفة بالبكتيريا. في بداية الإصابة بداء المتدثرة، عادةً تظهر أعراض قليلة، أو قد لا تظهر أي أعراض على الإطلاق. وفي حال وجود أعراض، فإنها تظهر خلال مدة بين 5 أيام، و 14 يومًا من التعرض للجراثيم المسببة لداء المتدثرة، وقد تكون تلك الأعراض خفيفة. المؤشرات، والأعراض تشمل : أعراض مرض السيلان (Gonorrhea) السيلان: عدوى تصيب الجهاز التناسلي، بسبب نوع من البكتيريا. عادةً تظهر أعراض الإصابة في الجهاز التناسلي الأنثوي خلال 10 أيام من التعرُّض للعدوى. أما في الجهاز التناسلي الذكري، فعادةً تبدأ الأعراض خلال 5 أيام من التعرُّض للعدوى. يمكن أن تشمل أعراض السيلان ما يأتي: يمكن أن تنمو الجراثيم المسببة للسيلان أيضًا في الفم، والحلق، والعينين، والمفاصل، مثل: مفصلي الركبة. وقد تشمل أعراض مرض السيلان في أجزاء الجسم الأخرى –غير الجهاز التناسلي– ما يأتي: أعراض داء المشعرات (Trichomoniasis) داء المشعرات: أحد الأنواع الشائعة من العدوى المنقولة جنسيًا، ويسببه أحد الطفيليات متناهية الصغر، التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. ويُطلق على هذا النوع من الطفيليات اسم المشعَّرة المهبلية. ينتشر هذا الطفيل أثناء الجماع مع شخص مصاب بالعدوى، ويصيب في الغالب المهبل، أو الفرج، أو عنق الرحم. كثيرًا ما تصيب هذه العدوى الأنبوب الذي يخرج البول من خلاله، من القضيب، أو المهبل، ويُسمى الإحليل. عندما يسبب داء المُشعَّرات ظهور أعراض معينة، فإنها قد تظهر في مدة من 5 أيام إلى 28 يومًا من التعرض للطفيل. وتتراوح الأعراض ما بين تهيُّج طفيف، إلى التهاب خطير يتخذ شكل تورُّم. يمكن أن تشمل أعراض داء المُشعَّرات: أعراض فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) يعني مرض فيروس نقص المناعة البشري الإصابة بعدوى هذا الفيروس. يؤثر فيروس نقص المناعة البشري في قدرة الجسم على محاربة الفيروسات، والبكتيريا، والفطريات المسببة للأمراض. وهو المسبب لمرض الإيدز، وهو مرض مزمن، وقد يكون سببًا للوفاة. تختلف أعراض فيروس نقص المناعة البشري باختلاف مدة الإصابة به، وما إذا كان المريض يتلقى علاجًا له أم لا. الأعراض المبكرة يسبب فيروس نقص المناعة البشري في الأغلب أعراضًا تشبه أعراض الإنفلونزا بعد التعرض للعدوى بمدة من أسبوعين إلى أربعة أسابيع. وقد تستمر تلك الأعراض لبضعة أيام، أو أسابيع، ينسخ خلالها الفيروس نفسه بسرعة كبيرة. واحتمال انتقال هذا المرض إلى الزوج، أو الزوجة عند ممارسة الجنس كبير. يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة لفيروس نقص المناعة البشري: الطريقة الوحيدة لاكتشاف الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، هي إجراء الاختبار الأعراض المزمنة، أو أعراض المرحلة المتوسطة لمرض فيروس نقص المناعة البشري مع مرور الوقت، يستمر الفيروس في نسخ نفسه، ولكن بمعدلات أقل. وتسمى هذه المرحلة بمرحلة العدوى المزمنة. وقد لا تظهر أعراض على المصاب خلال هذه الفترة. ويمكن للمصاب بفيروس نقص المناعة البشري البقاء في هذه المرحلة مدى الحياة، إذا ما التزم بتلقي أدوية هذا الفيروس المسماة بالعلاج المضاد للفيروسات القهقرية طبقًا للتعليمات. قد تتطور المرحلة المزمنة من عدوى فيروس نقص المناعة البشري -حال تركها دون علاج- إلى مرض الإيدز في غضون 10 سنوات تقريبًا. الإصابة بالإيدز تهدد حياة المريض. تشمل أعراض مرض الإيدز ما يأتي: أعراض الهربس التناسلي (Genital Herpes) داء الهربس التناسلي هو: عدوى منقولة جنسيًا تنتشر بسهولة، وتسببها سلالة من فيروس الهربس البسيط. يتسلل الفيروس إلى الجسم عبر الشقوق الصغيرة في الجلد، أو الأغشية المخاطية. ومعظم المصابين بهذا الفيروس لا يدرون عن الإصابتهم به؛ إذ لا تظهر عليهم أعراض، أو تكون خفيفة لا تلفت الانتباه. وإن ظهرت أعراض، فغالبًا تبرز خلال 12 يومًا من التعرض للعدوى. إذا لوحظت أعراض الهربس، فإن المرة الأولى تكون عادةً الأشد. وقد لا تعاود الأعراض البعض مجددًا، بينما تظل متقطعة لدى آخرين على مدار سنوات عديدة. تشمل أعراض الهربس التناسلي ما يأتي: قد تجعل القُرح التبول مؤلمًا، كما قد يعاني المصاب من ألم، وتقيح في المنطقة التناسلية،

د.فهد السديري | استشاري الجلدية
لقراءه المقال